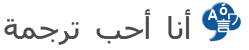- النص
- تاريخ
Culture et religion, le temps de la
Culture et religion, le temps de la « sainte ignorance »
La déconnexion culture – religion
Le philosophe et sociologue Olivier Roy vient de publier un livre sur les rapports entre la religion et la
culture1. Cet ouvrage très documenté propose une analyse fouillée et pose des questions difficiles
sur le positionnement des religions au sein de la mondialisation.
L’auteur analyse l’histoire des liens entre culture et religion. Au XXIème siècle nous entrons dans une
relation inédite et qui n’est pas sans poser des questions décisives aux quelles il n’est pas simple de
répondre.
Après des siècles où la religion était en connexion étroite avec la culture, nous connaissons des
temps où la rupture est de plus en plus marquée entre les deux. La longue période où chacun dans la
société partageait peu ou prou les mêmes valeurs morales qu’il soit croyant ou non, catholique ou
anticlérical, est derrière nous. La référence religieuse sous jacente à la vie sociale se marginalise et
sort de plus en plus du champ culturel. Les nouveaux comportements et valeurs s’individualisent et
s’éloignent de toute référence religieuse. La culture repousse la religion au dehors. Elle s’installe
dans la « sainte ignorance », dans l’absence de connaissance religieuse. Mais c’est aussi la religion
elle‐même qui, portant un regard de plus en plus critique sur la culture contemporaine dans laquelle
elle perçoit une résurgence de formes païennes, prend distance.
Or, en se découplant de la culture, la religion prend une forme plus radicale. Affranchie des
compromissions avec les cultures particulières, elle devient pure et dure.
Pour l’auteur, la culture est en effet ce qui rend le religieux plus ouvert et plus englobant. Quand la
culture et la religion étaient liées ensemble, ce qui importait alors c’était la conformité des
comportements bien plus que l’adhésion de la foi. Du même coup, tout un dégradé d’appartenances
était admis. Il était possible de se reconnaître chrétien sans témoigner pour autant d’une grande
ferveur croyante. En retour, la religion apportait ses repères moraux, sa symbolique unificatrice et
son sens à l’existence.
En terre trégorroise, par exemple, il n’y a pas si longtemps, on pouvait être non croyant et pourtant
accepté comme catholique pourvu que certains marqueurs fussent respectés : un minimum de
pratique religieuse, une conformité des actes publics à ses valeurs morales. Dans ce contexte, le
catholicisme supportait les tièdes.
A l’inverse du catholicisme, le protestantisme dans ses formes évangélique et pentecôtiste s’est
construit dans un hors champ de la culture. Très vite, il s’est opposé à la culture quelle qu’elle soit
considérée d’emblée comme païenne. Il appelle à s’engager totalement dans la foi, dans l’obéissance
aux préceptes moraux et la soumission à la Parole. Dégagée de toute culture, la religion redevient
« pure ».
Cette forme religieuse est en phase avec notre temps. Parce qu’elle répond à la quête identitaire,
communautariste, affective et mobile, elle est mondiale. Affranchie de la culture, la religion se
radicalise et se délocalise. Elle se fait prosélyte. Elle simplifie son dogme et son histoire, jusqu’à
parfois mépriser la science théologique, d’où ici aussi une « sainte ignorance ». Les
fondamentalismes et les extrémismes trouvent là leur terreau. Partout, de plus en plus d’hommes et
1 Olivier Roy, « La sainte ignorance » le temps de la religion sans culture
éditions du seuil, octobre 2008
La déconnexion culture – religion
Le philosophe et sociologue Olivier Roy vient de publier un livre sur les rapports entre la religion et la
culture1. Cet ouvrage très documenté propose une analyse fouillée et pose des questions difficiles
sur le positionnement des religions au sein de la mondialisation.
L’auteur analyse l’histoire des liens entre culture et religion. Au XXIème siècle nous entrons dans une
relation inédite et qui n’est pas sans poser des questions décisives aux quelles il n’est pas simple de
répondre.
Après des siècles où la religion était en connexion étroite avec la culture, nous connaissons des
temps où la rupture est de plus en plus marquée entre les deux. La longue période où chacun dans la
société partageait peu ou prou les mêmes valeurs morales qu’il soit croyant ou non, catholique ou
anticlérical, est derrière nous. La référence religieuse sous jacente à la vie sociale se marginalise et
sort de plus en plus du champ culturel. Les nouveaux comportements et valeurs s’individualisent et
s’éloignent de toute référence religieuse. La culture repousse la religion au dehors. Elle s’installe
dans la « sainte ignorance », dans l’absence de connaissance religieuse. Mais c’est aussi la religion
elle‐même qui, portant un regard de plus en plus critique sur la culture contemporaine dans laquelle
elle perçoit une résurgence de formes païennes, prend distance.
Or, en se découplant de la culture, la religion prend une forme plus radicale. Affranchie des
compromissions avec les cultures particulières, elle devient pure et dure.
Pour l’auteur, la culture est en effet ce qui rend le religieux plus ouvert et plus englobant. Quand la
culture et la religion étaient liées ensemble, ce qui importait alors c’était la conformité des
comportements bien plus que l’adhésion de la foi. Du même coup, tout un dégradé d’appartenances
était admis. Il était possible de se reconnaître chrétien sans témoigner pour autant d’une grande
ferveur croyante. En retour, la religion apportait ses repères moraux, sa symbolique unificatrice et
son sens à l’existence.
En terre trégorroise, par exemple, il n’y a pas si longtemps, on pouvait être non croyant et pourtant
accepté comme catholique pourvu que certains marqueurs fussent respectés : un minimum de
pratique religieuse, une conformité des actes publics à ses valeurs morales. Dans ce contexte, le
catholicisme supportait les tièdes.
A l’inverse du catholicisme, le protestantisme dans ses formes évangélique et pentecôtiste s’est
construit dans un hors champ de la culture. Très vite, il s’est opposé à la culture quelle qu’elle soit
considérée d’emblée comme païenne. Il appelle à s’engager totalement dans la foi, dans l’obéissance
aux préceptes moraux et la soumission à la Parole. Dégagée de toute culture, la religion redevient
« pure ».
Cette forme religieuse est en phase avec notre temps. Parce qu’elle répond à la quête identitaire,
communautariste, affective et mobile, elle est mondiale. Affranchie de la culture, la religion se
radicalise et se délocalise. Elle se fait prosélyte. Elle simplifie son dogme et son histoire, jusqu’à
parfois mépriser la science théologique, d’où ici aussi une « sainte ignorance ». Les
fondamentalismes et les extrémismes trouvent là leur terreau. Partout, de plus en plus d’hommes et
1 Olivier Roy, « La sainte ignorance » le temps de la religion sans culture
éditions du seuil, octobre 2008
0/5000
الثقافة والدين، الوقت ' الجهل المقدس.قطع اتصال الثقافة-الدينالفيلسوف وعالم الاجتماع روي Olivier فقط نشرت كتاباً عن العلاقة بين الدينculture1. هذا الكتاب مدروسة جيدا ويقدم تحليلاً دقيقا ويسأل أسئلة صعبةفي تحديد المواقع للأديان إطار العولمة.ويحلل المؤلف تاريخ الصلات بين الثقافة والدين. في القرن الحادي والعشرين ونحن ندخلعلاقة جديدة ولا يخلو من الأسئلة الحاسمة بما أنه ليس من السهل إلىالاستجابة.وبعد قرون عندما كان الدين في اتصال وثيق مع الثقافة، ونحن نعرفحيث التمزق يتسم أكثر فأكثر بين البلدين. فترة طويلة حيث الجميع فيشركة مشتركة قليلة أو أقل من القيم الأخلاقية نفسها عما إذا كان مؤمناً أو لا، الكاثوليكية أوللاكليروس، وراءنا. المرجعية الدينية التي تقوم عليها الحياة الاجتماعية هو التهميش ومزيد من المعلومات بالإضافة إلى المجال الثقافي. سلوكيات جديدة وقيم واضحة وبعيداً عن أي مرجعية دينية. يدفع الثقافة والدين إلى الخارج. انتقلتفي 'المقدسة الجهل'، وفي غياب المعرفة الدينية. ولكن كما أنها ديننفسها، التي تحمل نظرة انتقاد أكثر وأكثر على الثقافة المعاصرة التيوقالت أنها ترى عودة ظهور أشكال الوثنية، يأخذ مسافة.من غير فصل الثقافة، الدين يأخذ شكلاً أكثر تطرفاً. إطلاق سراح منحلول توفيقية مع ثقافات معينة، يصبح نقية والثابت.لمقدم البلاغ، الثقافة ما يجعل فتح أكثر دينية وأكثر شمولاً. عندالثقافة والدين مرتبطة معا، ما كان ذلك مهما كان الامتثالسلوك أكثر من عضوية الإيمان. في الوقت نفسه، على عضوية التدرجوقد اعترف. كان من الممكن الاعتراف بالمسيحية دون الشاهد قدم كبيرالحماس الديني. في المقابل، جلب الدين له محامل أخلاقية، لها رمزية موحدة وإحساسه بالوجود.تريجورويسي الترابية، على سبيل المثال، لم يكن ذلك منذ فترة طويلة، يمكن أن تكون غير الاعتقاد وبعدقبلت كالكاثوليك شريطة أن تتحقق بعض علامات: كحد أدنىممارسة الشعائر الدينية، الامتثال للأفعال العامة القيم الأخلاقية. وفي هذا السياق،وكانت الكاثوليكية الحارة.وخلافا للكاثوليكية، البروتستانتية في أشكالها الإنجيلية والخمسينيةبنيت في حقل خارج الثقافة. بسرعة كبيرة، ويعارض بالثقافة على الإطلاقاعتبار لاغان. أنه يدعو إلى المشاركة الكاملة في الإيمان، في الطاعةللمبادئ الأخلاقية الأساسية وتقديمها للكلمة. يصبح الدين واضحة من أي ثقافة،«الصرفة»هذا النموذج الديني في تناغم مع عصرنا. نظراً لأنه يفي بالسعي إلى الهويةالمجتمعي، العاطفية والمتنقلة، أنها عالمية. تحرر من الثقافة، دينراديكالية ونقل. أنها تحصل على المرتد. أنه يبسط العقيدة وتاريخها، وتصل إلىفي بعض الأحيان يحتقر علوم اللاهوت، حيث هنا أيضا ' الجهل المقدس. علىالأصولية والتطرف هناك تربية على الأرض. الرجال في كل مكان، وأكثر وأكثر و1 روي Olivier، دين 'الجهل المقدس' بدون وقت الثقافةأصدرت دار دو seuil، تشرين الأول/أكتوبر 2008
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..


الثقافة والدين، والوقت من "الجهل المقدس"
فصل الثقافة - الدين
والفيلسوف وعالم الاجتماع أوليفييه روي مؤخرا بنشر كتاب عن العلاقة بين الدين
وculture1. يقدم هذا الكتاب مدروسة جيدا تحليلا مفصلا ويطرح أسئلة صعبة
حول المواقع الأديان في العولمة.
يحلل المؤلف تاريخ الصلات بين الثقافة والدين. في القرن الحادي والعشرين ونحن مقبلون على
العلاقة الفريدة التي لا تخلو من السؤال الحاسم الذي ليس من السهل
الإجابة.
بعد قرون التي كان متصلا بشكل وثيق مع الدين والثقافة، ونحن نعلم
وقت كسر هو أكثر وضوحا بين. لفترة طويلة يشارك فيها الجميع في
شركة مشتركة أكثر أو أقل من القيم الأخلاقية نفسها سواء مؤمن أم لا، الكاثوليكية أو
مقاوم للاكليروس، وراءنا. والمرجعية الدينية الكامنة في المجتمع تهميش
ويترك أكثر من المجال الثقافي. السلوكيات والقيم الجديدة هي فردية
والابتعاد عن أي مرجعية دينية. الثقافة تحيل الدين خارج. انتقلت
إلى "الجهل المقدس"، والافتقار إلى المعرفة الدينية. ولكنه أيضا دين
نفسه، وهو يرتدي مظهر انتقادات متزايدة في الثقافة المعاصرة التي
ترى تجدد أشكال الوثنية، ويأخذ بعيدا.
وبحلول فصل الثقافة، ويأخذ الدين ل معظم شكل جذري. تحررت من
التنازلات مع ثقافات معينة، يصبح واضح وبسيط.
وبالنسبة للمؤلف، والثقافة، هو في الواقع مما يجعلها أكثر انفتاحا وأكثر شمولية دينية. عندما
تم ربط الثقافة والدين معا، ما يهم ثم كانت مطابقة
السلوك أكثر بكثير من الانضمام للإيمان. في نفس الوقت، في حين أن التدرج بالانتماء
واعترف. كان من الممكن التعرف على المسيحية دون تقديم الشهود عظيم
مؤمن الحماس. في المقابل، وجهت الدين البوصلة الأخلاقية له، ورمزي موحد لها
معنى للوجود.
في trégorroise الأرض، على سبيل المثال، ليس هناك فترة طويلة، يمكن أن يكون كافر وبعد
قبوله ما دام بعض الكاثوليكية وقد لوحظت علامات: ما لا يقل عن
الممارسة الدينية، والامتثال للوثائق العامة للقيم الأخلاقية. في هذا السياق،
والكاثوليكية دعمت فاتر.
في المقابل إلى الكاثوليكية والبروتستانتية في أشكاله الإنجيلية والخمسينية
وبنيت في حقل خارج الثقافة. قريبا، أنه يعارض الثقافة من أي نوع
وثنية تعتبر دائما. ويدعو إلى الالتزام الكامل في الإيمان والطاعة
لتعاليم أخلاقية وعرضها على الكلمة. خالية من أي ثقافة، ويصبح الدين
"نقية".
هذا الشكل الديني في تناغم مع عصرنا. لأنه يستجيب للبحث عن الهوية،
مجتمعي، الوجدانية والمتنقلة، فمن العالمي. الافراج عن الثقافة والدين
التطرف وإلى إعادة تحديد موقع. انها تحصل على المرتد. فإنه يبسط عقيدته وتاريخه، حتى
يحتقر بعض الأحيان العلوم اللاهوتية، التي هنا أيضا "الجهل المقدس". والأصولية والتطرف تجد على أرض الواقع هناك.
في كل مكان، والمزيد من الرجال
و1 أوليفييه روي، "إن الجهل المقدس" الوقت دين بلا ثقافة
طبعات العتبة، أكتوبر 2008
فصل الثقافة - الدين
والفيلسوف وعالم الاجتماع أوليفييه روي مؤخرا بنشر كتاب عن العلاقة بين الدين
وculture1. يقدم هذا الكتاب مدروسة جيدا تحليلا مفصلا ويطرح أسئلة صعبة
حول المواقع الأديان في العولمة.
يحلل المؤلف تاريخ الصلات بين الثقافة والدين. في القرن الحادي والعشرين ونحن مقبلون على
العلاقة الفريدة التي لا تخلو من السؤال الحاسم الذي ليس من السهل
الإجابة.
بعد قرون التي كان متصلا بشكل وثيق مع الدين والثقافة، ونحن نعلم
وقت كسر هو أكثر وضوحا بين. لفترة طويلة يشارك فيها الجميع في
شركة مشتركة أكثر أو أقل من القيم الأخلاقية نفسها سواء مؤمن أم لا، الكاثوليكية أو
مقاوم للاكليروس، وراءنا. والمرجعية الدينية الكامنة في المجتمع تهميش
ويترك أكثر من المجال الثقافي. السلوكيات والقيم الجديدة هي فردية
والابتعاد عن أي مرجعية دينية. الثقافة تحيل الدين خارج. انتقلت
إلى "الجهل المقدس"، والافتقار إلى المعرفة الدينية. ولكنه أيضا دين
نفسه، وهو يرتدي مظهر انتقادات متزايدة في الثقافة المعاصرة التي
ترى تجدد أشكال الوثنية، ويأخذ بعيدا.
وبحلول فصل الثقافة، ويأخذ الدين ل معظم شكل جذري. تحررت من
التنازلات مع ثقافات معينة، يصبح واضح وبسيط.
وبالنسبة للمؤلف، والثقافة، هو في الواقع مما يجعلها أكثر انفتاحا وأكثر شمولية دينية. عندما
تم ربط الثقافة والدين معا، ما يهم ثم كانت مطابقة
السلوك أكثر بكثير من الانضمام للإيمان. في نفس الوقت، في حين أن التدرج بالانتماء
واعترف. كان من الممكن التعرف على المسيحية دون تقديم الشهود عظيم
مؤمن الحماس. في المقابل، وجهت الدين البوصلة الأخلاقية له، ورمزي موحد لها
معنى للوجود.
في trégorroise الأرض، على سبيل المثال، ليس هناك فترة طويلة، يمكن أن يكون كافر وبعد
قبوله ما دام بعض الكاثوليكية وقد لوحظت علامات: ما لا يقل عن
الممارسة الدينية، والامتثال للوثائق العامة للقيم الأخلاقية. في هذا السياق،
والكاثوليكية دعمت فاتر.
في المقابل إلى الكاثوليكية والبروتستانتية في أشكاله الإنجيلية والخمسينية
وبنيت في حقل خارج الثقافة. قريبا، أنه يعارض الثقافة من أي نوع
وثنية تعتبر دائما. ويدعو إلى الالتزام الكامل في الإيمان والطاعة
لتعاليم أخلاقية وعرضها على الكلمة. خالية من أي ثقافة، ويصبح الدين
"نقية".
هذا الشكل الديني في تناغم مع عصرنا. لأنه يستجيب للبحث عن الهوية،
مجتمعي، الوجدانية والمتنقلة، فمن العالمي. الافراج عن الثقافة والدين
التطرف وإلى إعادة تحديد موقع. انها تحصل على المرتد. فإنه يبسط عقيدته وتاريخه، حتى
يحتقر بعض الأحيان العلوم اللاهوتية، التي هنا أيضا "الجهل المقدس". والأصولية والتطرف تجد على أرض الواقع هناك.
في كل مكان، والمزيد من الرجال
و1 أوليفييه روي، "إن الجهل المقدس" الوقت دين بلا ثقافة
طبعات العتبة، أكتوبر 2008
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..


الثقافة الدينية المقدسة، "الجهل"
فصل الثقافة الدينية – الفلاسفة وعلماء الاجتماع روي نشرت للتو كتاب شجرة الزيتون في العلاقة بين الدين و culture1
.وهذا الكتاب يقدم تحليل شامل و التعمق في دراسة هذه المشكلة من الصعب وضع الدين في العولمة
.الكاتب يحلل العلاقة بين التاريخ والثقافة والدين.في القرن 21، ونحن ندخل من جديد
لا تسأل ما علاقة حاسمة ليست بسيطة
الرد....... منذ قرون، الدين هو الثقافة في عصرنا هو تزايد
خطأ بين.كل شخص في المجتمع على المدى الطويل حصة
أكثر أو أقل نفس القيم الأخلاقية، هو غير المؤمنين أو الكنيسة الكاثوليكية أو
ضد الحق، خلفنا.الدين في الحياة الاجتماعية المحتملة التهميش
يخرج المزيد من المجالات الثقافية.سلوكيات جديدة و قيمة و شخصية
بعيدا عن أي دين.الثقافة الدينية مستبعدة.جلست "مقدس"
من الجهل في عدم المعرفة الدينية.ولكن هذا هو الدين نفسه تحمل
نظرة النقد المتزايد في الثقافة المعاصرة
انها سوف تجدد الكفار شكل
فصل الثقافة في المسافة.الدين هو أكثر راديكالية.لا حل وسط
و ثقافة معينة، أصبحت مجرد.......
الكاتب، هو في الواقع جعل الثقافة الدينية أكثر انفتاحا و مغلقة.عندما
الثقافة و الدين معا، هذا هو المهم، وهذا يتفق مع السلوك
من دخول الإيمان.وفي الوقت نفسه، ولاء نحط
جائز.ربما لا تعرف المسيح ولكن
حماسة المؤمنين.في المقابل، توفر الأخلاق الدينية أهمية رمزية موحدة
هناك....... tr é gorroise، على سبيل المثال، منذ وقت ليس ببعيد، ونحن قد لا نعتقد ذلك، ولكن
أعتقد طالما هو احترام بعض علامات الكاثوليكية: الحد الأدنى
الممارسة الدينية، ودمج القيم الأخلاقية في السلوك العام.وفي هذا السياق،
من الحارة الكاثوليكية....... ضد المسيحية الإنجيلية الخمسينية و شكل مبنية على ثقافة البورصة
.قريبا،انه ضد ثقافة سواء في البداية تعتبر وثنية
.ودعا إلى الإيمان الكامل، طاعة
الوصايا الأخلاقية وتقديم الكلمات.مسح جميع الثقافة الدينية، أصبح "نقية"
شكل لنا هذا الدين..............لأنها تلبي السعي هوية المجتمع،
،و الدافع العاطفي هو عالمي.أي ثقافة دينية
إلى الانتقال.كانت من المؤمنين الجدد.وهو تبسيط العقائد و قصته، حتى في بعض الأحيان احتقار العلم
اللاهوت، هنا أيضا المقدسة "الجهل".
الأصولية والتطرف هنا مرتع لهم.في كل مكان، المزيد والمزيد من الناس
1 أوليفييه روي،"الجهل" الثقافة الدينية المقدسة من الوقت لا
إصدارات العتبة، تشرين الأول / أكتوبر 2008
فصل الثقافة الدينية – الفلاسفة وعلماء الاجتماع روي نشرت للتو كتاب شجرة الزيتون في العلاقة بين الدين و culture1
.وهذا الكتاب يقدم تحليل شامل و التعمق في دراسة هذه المشكلة من الصعب وضع الدين في العولمة
.الكاتب يحلل العلاقة بين التاريخ والثقافة والدين.في القرن 21، ونحن ندخل من جديد
لا تسأل ما علاقة حاسمة ليست بسيطة
الرد....... منذ قرون، الدين هو الثقافة في عصرنا هو تزايد
خطأ بين.كل شخص في المجتمع على المدى الطويل حصة
أكثر أو أقل نفس القيم الأخلاقية، هو غير المؤمنين أو الكنيسة الكاثوليكية أو
ضد الحق، خلفنا.الدين في الحياة الاجتماعية المحتملة التهميش
يخرج المزيد من المجالات الثقافية.سلوكيات جديدة و قيمة و شخصية
بعيدا عن أي دين.الثقافة الدينية مستبعدة.جلست "مقدس"
من الجهل في عدم المعرفة الدينية.ولكن هذا هو الدين نفسه تحمل
نظرة النقد المتزايد في الثقافة المعاصرة
انها سوف تجدد الكفار شكل
فصل الثقافة في المسافة.الدين هو أكثر راديكالية.لا حل وسط
و ثقافة معينة، أصبحت مجرد.......
الكاتب، هو في الواقع جعل الثقافة الدينية أكثر انفتاحا و مغلقة.عندما
الثقافة و الدين معا، هذا هو المهم، وهذا يتفق مع السلوك
من دخول الإيمان.وفي الوقت نفسه، ولاء نحط
جائز.ربما لا تعرف المسيح ولكن
حماسة المؤمنين.في المقابل، توفر الأخلاق الدينية أهمية رمزية موحدة
هناك....... tr é gorroise، على سبيل المثال، منذ وقت ليس ببعيد، ونحن قد لا نعتقد ذلك، ولكن
أعتقد طالما هو احترام بعض علامات الكاثوليكية: الحد الأدنى
الممارسة الدينية، ودمج القيم الأخلاقية في السلوك العام.وفي هذا السياق،
من الحارة الكاثوليكية....... ضد المسيحية الإنجيلية الخمسينية و شكل مبنية على ثقافة البورصة
.قريبا،انه ضد ثقافة سواء في البداية تعتبر وثنية
.ودعا إلى الإيمان الكامل، طاعة
الوصايا الأخلاقية وتقديم الكلمات.مسح جميع الثقافة الدينية، أصبح "نقية"
شكل لنا هذا الدين..............لأنها تلبي السعي هوية المجتمع،
،و الدافع العاطفي هو عالمي.أي ثقافة دينية
إلى الانتقال.كانت من المؤمنين الجدد.وهو تبسيط العقائد و قصته، حتى في بعض الأحيان احتقار العلم
اللاهوت، هنا أيضا المقدسة "الجهل".
الأصولية والتطرف هنا مرتع لهم.في كل مكان، المزيد والمزيد من الناس
1 أوليفييه روي،"الجهل" الثقافة الدينية المقدسة من الوقت لا
إصدارات العتبة، تشرين الأول / أكتوبر 2008
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..


لغات أخرى
دعم الترجمة أداة: الآيسلندية, الأذرية, الأردية, الأفريقانية, الألبانية, الألمانية, الأمهرية, الأوديا (الأوريا), الأوزبكية, الأوكرانية, الأويغورية, الأيرلندية, الإسبانية, الإستونية, الإنجليزية, الإندونيسية, الإيطالية, الإيغبو, الارمنية, الاسبرانتو, الاسكتلندية الغالية, الباسكية, الباشتوية, البرتغالية, البلغارية, البنجابية, البنغالية, البورمية, البوسنية, البولندية, البيلاروسية, التاميلية, التايلاندية, التتارية, التركمانية, التركية, التشيكية, التعرّف التلقائي على اللغة, التيلوجو, الجاليكية, الجاوية, الجورجية, الخؤوصا, الخميرية, الدانماركية, الروسية, الرومانية, الزولوية, الساموانية, الساندينيزية, السلوفاكية, السلوفينية, السندية, السنهالية, السواحيلية, السويدية, السيبيوانية, السيسوتو, الشونا, الصربية, الصومالية, الصينية, الطاجيكي, العبرية, العربية, الغوجراتية, الفارسية, الفرنسية, الفريزية, الفلبينية, الفنلندية, الفيتنامية, القطلونية, القيرغيزية, الكازاكي, الكانادا, الكردية, الكرواتية, الكشف التلقائي, الكورسيكي, الكورية, الكينيارواندية, اللاتفية, اللاتينية, اللاوو, اللغة الكريولية الهايتية, اللوكسمبورغية, الليتوانية, المالايالامية, المالطيّة, الماورية, المدغشقرية, المقدونية, الملايو, المنغولية, المهراتية, النرويجية, النيبالية, الهمونجية, الهندية, الهنغارية, الهوسا, الهولندية, الويلزية, اليورباية, اليونانية, الييدية, تشيتشوا, كلينجون, لغة هاواي, ياباني, لغة الترجمة.
- Helthis is not about a suffering life wi
- Culture et religion, le temps de la « sa
- احبك
- امارس ايضا
- I hope you are always fineAnd i also fin
- Culture et religion, le temps de la « sa
- احبك
- اجمل صديقه الى
- احبك
- the consequences of a serious interrupti
- وانت من اهل الخير
- يخرج
- انا معجب بك كثيرا
- Mahal kita
- انا معجب بك كثيرا
- امارس
- this is not about a suffering life with
- Culture et religion, le temps de la « sa
- Carry on
- Você me enviou uma mensagemAcimaVocê wal
- كفالة حضورية غرامية السلام عليكم ورحمة ا
- I hope you are always fineAnd i also fin
- Você me enviou uma mensagemAcimaVocê wal
- ولك ايضا