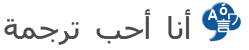- النص
- تاريخ
5/La diplomatie économique des entr
5/La diplomatie économique des entreprises
parFrançois Pitti
Vice-président des alliances stratégiques d’un groupe du CAC 40 et conseiller du commerce extérieur.
L e magazine américain Wired prônait en octobre 2010 l’enseignement de sept nouvelles disciplines jugées indispensables pour comprendre le XXIe siècle. En bonne place figurait la diplomatie non étatique, en particulier celle des entreprises.
2
Le monde nouveau, globalisé et interconnecté, est tridimensionnel. Les États, concentrant les pouvoirs jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, ont vu leur nombre multiplié par quatre depuis. Leur puissance relative, diluée, a diminué d’autant. L’endettement public endémique depuis une génération, hors grands émergents ou pays rentiers, a accentué cette tendance. Dans le même temps, l’émergence de groupes multinationaux – en accélération depuis les années 1970 – s’est traduite par l’apparition d’acteurs plus puissants que nombre de pays. Enfin, l’explosion d’Internet a permis pendant la dernière décennie l’essor d’influentes tribus mondiales fédérant les idées, les opinions, parfois les idéologies.
3
Durant la Guerre froide, de nombreuses relations interétatiques se structuraient autour des relations des deux superpuissances et de leurs blocs respectifs. Deux générations plus tard ce sont près de 1 000 acteurs (les 300 plus grands États et régions, les groupes des Fortune 500 et les 200 ONG ou mouvements d’opinion dominants) qui façonnent les grandes tendances. Tous évoluent dans un mouvement brownien modelé par les millions de liens tissés entre les trois dimensions.
4
Deux aspects deviennent fondamentaux dans ce monde instable et « liquide ». Chaque acteur, multipliant de fait les interactions, cherche à maximiser le gain induit par des relations constructives (partenariats) et à minimiser les conflits.
5
Cette double priorité correspond précisément aux deux piliers de la diplomatie. Dans un environnement en pleine transformation, les entreprises y ont un recours croissant.
Pourquoi une diplomatie économique d’entreprise ?
6
Les entreprises doivent s’adapter au nouveau paradigme et les structures classiques de relation avec l’extérieur, quoique nécessaires, ne suffisent plus.
7
Les vecteurs traditionnels de la publicité et de la communication sont souvent trop passifs dans un monde mouvant. Ils ne sont, dans leur forme originelle, plus adaptés à un besoin de réaction immédiat lors des interactions avec les États ou avec les millions de « consommacteurs » qui se fédèrent rapidement.
8
Par ailleurs, les fonctions « relations extérieures » et « lobbying » qui peuvent influer sur les normes, les règles et parfois les lois sont souvent perçues par les opinions publiques comme tentant indûment d’influencer la souveraineté étatique – cela même lorsque l’État sollicite les avis des industriels.
9
La diplomatie économique des entreprises tente de répondre à des besoins nouveaux en combinant plusieurs éléments jusqu’ici disjoints :
• elle s’inscrit dans le long terme tout en réagissant en temps réel ;
• elle a trait principalement à des relations hétérogènes (entreprises-États, entreprises-ONG, sociétés-mouvements d’opinion…) ;
• elle a un rôle préventif dans un monde où les conflits se banalisent.
En outre, elle partage avec la diplomatie classique trois caractéristiques fondamentales : elle se focalise en priorité sur les interactions transnationales. Elle est décidée au plus haut niveau des organisations : États, sociétés ou associations. Enfin, elle accorde une importance stratégique à la perception internationale.
10
La diplomatie économique sert les objectifs clés des entreprises, au premier chef desquels la valorisation globale de la société.
11
La perception de valeur des entreprises a beaucoup évolué en quelques décennies. D’abord mesurée à l’aune du périmètre et donc des ventes, elle a rapidement pris en compte les profits nets actualisés, puis la capitalisation. Au-delà du poids boursier, la valeur commence à intégrer le rayonnement de la marque et la réputation des sociétés. Les enjeux sont considérables dans un monde bombardé d’informations où – paradoxalement – la marque permet de se « dé » marquer. Le cabinet Interbrand a publié en septembre 2010 son classement des 100 plus grandes marques mondiales. Coca Cola s’y adjuge la première place avec une valorisation estimée à 70,4 milliards de dollars. La marque Toyota, impactée par l’image catastrophique en février 2010 du rappel de huit de ses modèles (pour des problèmes de pédale d’accélérateur) perd 16 % à 26,2 milliards de dollars. Le Reputation Institute de plus en plus suivi par les associations de consommateurs épingle également Toyota et en fait un cas d’école sur son site Internet. Enfin, BP se voit bouté hors du classement suite au désastre écologique américain Deepwater tandis que son concurrent Shell grimpe de près de dix places.
12
Signe de l’imbrication croissante des sphères politique et économique, les diplomaties économiques influent sur les diplomaties politiques. Les dynamiques à l’œuvre sont très diverses.
13
Dans le cas BP, la crise a provoqué une tension politique palpable entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. On se souvient des frictions entre Barack Obama et le gouvernement de Gordon Brown lors des attaques répétées du président américain envers l’ancien British Petroleum (tentant difficilement de sauvegarder son nouveau positionnement de Beyond Petroleum).
14
Le cas Toyota, quoique différent, est également symptomatique de la forte corrélation entre la marque de grandes entreprises et l’image des États. Quelques jours après avoir présenté ses excuses devant le Parlement américain, le P.-D.G. Akio Toyoda a fait de même envers la Chine. Loin d’être soutenu par le gouvernement japonais, la société devenue symbole de la qualité made in Japan s’est fait vertement rabrouer par le ministre des Affaires étrangères Katsuya Okada ainsi que le ministre des Transports Seiji Maehara. Pour eux, à travers Toyota, c’est l’image du Japon qui était ternie.
15
Les déboires des géants automobile et pétrolier illustrent l’interdépendance des diplomaties économiques des pays et des entreprises et la nécessité pour les acteurs privés et publics d’intégrer cette imbrication dans leur stratégie.
parFrançois Pitti
Vice-président des alliances stratégiques d’un groupe du CAC 40 et conseiller du commerce extérieur.
L e magazine américain Wired prônait en octobre 2010 l’enseignement de sept nouvelles disciplines jugées indispensables pour comprendre le XXIe siècle. En bonne place figurait la diplomatie non étatique, en particulier celle des entreprises.
2
Le monde nouveau, globalisé et interconnecté, est tridimensionnel. Les États, concentrant les pouvoirs jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, ont vu leur nombre multiplié par quatre depuis. Leur puissance relative, diluée, a diminué d’autant. L’endettement public endémique depuis une génération, hors grands émergents ou pays rentiers, a accentué cette tendance. Dans le même temps, l’émergence de groupes multinationaux – en accélération depuis les années 1970 – s’est traduite par l’apparition d’acteurs plus puissants que nombre de pays. Enfin, l’explosion d’Internet a permis pendant la dernière décennie l’essor d’influentes tribus mondiales fédérant les idées, les opinions, parfois les idéologies.
3
Durant la Guerre froide, de nombreuses relations interétatiques se structuraient autour des relations des deux superpuissances et de leurs blocs respectifs. Deux générations plus tard ce sont près de 1 000 acteurs (les 300 plus grands États et régions, les groupes des Fortune 500 et les 200 ONG ou mouvements d’opinion dominants) qui façonnent les grandes tendances. Tous évoluent dans un mouvement brownien modelé par les millions de liens tissés entre les trois dimensions.
4
Deux aspects deviennent fondamentaux dans ce monde instable et « liquide ». Chaque acteur, multipliant de fait les interactions, cherche à maximiser le gain induit par des relations constructives (partenariats) et à minimiser les conflits.
5
Cette double priorité correspond précisément aux deux piliers de la diplomatie. Dans un environnement en pleine transformation, les entreprises y ont un recours croissant.
Pourquoi une diplomatie économique d’entreprise ?
6
Les entreprises doivent s’adapter au nouveau paradigme et les structures classiques de relation avec l’extérieur, quoique nécessaires, ne suffisent plus.
7
Les vecteurs traditionnels de la publicité et de la communication sont souvent trop passifs dans un monde mouvant. Ils ne sont, dans leur forme originelle, plus adaptés à un besoin de réaction immédiat lors des interactions avec les États ou avec les millions de « consommacteurs » qui se fédèrent rapidement.
8
Par ailleurs, les fonctions « relations extérieures » et « lobbying » qui peuvent influer sur les normes, les règles et parfois les lois sont souvent perçues par les opinions publiques comme tentant indûment d’influencer la souveraineté étatique – cela même lorsque l’État sollicite les avis des industriels.
9
La diplomatie économique des entreprises tente de répondre à des besoins nouveaux en combinant plusieurs éléments jusqu’ici disjoints :
• elle s’inscrit dans le long terme tout en réagissant en temps réel ;
• elle a trait principalement à des relations hétérogènes (entreprises-États, entreprises-ONG, sociétés-mouvements d’opinion…) ;
• elle a un rôle préventif dans un monde où les conflits se banalisent.
En outre, elle partage avec la diplomatie classique trois caractéristiques fondamentales : elle se focalise en priorité sur les interactions transnationales. Elle est décidée au plus haut niveau des organisations : États, sociétés ou associations. Enfin, elle accorde une importance stratégique à la perception internationale.
10
La diplomatie économique sert les objectifs clés des entreprises, au premier chef desquels la valorisation globale de la société.
11
La perception de valeur des entreprises a beaucoup évolué en quelques décennies. D’abord mesurée à l’aune du périmètre et donc des ventes, elle a rapidement pris en compte les profits nets actualisés, puis la capitalisation. Au-delà du poids boursier, la valeur commence à intégrer le rayonnement de la marque et la réputation des sociétés. Les enjeux sont considérables dans un monde bombardé d’informations où – paradoxalement – la marque permet de se « dé » marquer. Le cabinet Interbrand a publié en septembre 2010 son classement des 100 plus grandes marques mondiales. Coca Cola s’y adjuge la première place avec une valorisation estimée à 70,4 milliards de dollars. La marque Toyota, impactée par l’image catastrophique en février 2010 du rappel de huit de ses modèles (pour des problèmes de pédale d’accélérateur) perd 16 % à 26,2 milliards de dollars. Le Reputation Institute de plus en plus suivi par les associations de consommateurs épingle également Toyota et en fait un cas d’école sur son site Internet. Enfin, BP se voit bouté hors du classement suite au désastre écologique américain Deepwater tandis que son concurrent Shell grimpe de près de dix places.
12
Signe de l’imbrication croissante des sphères politique et économique, les diplomaties économiques influent sur les diplomaties politiques. Les dynamiques à l’œuvre sont très diverses.
13
Dans le cas BP, la crise a provoqué une tension politique palpable entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. On se souvient des frictions entre Barack Obama et le gouvernement de Gordon Brown lors des attaques répétées du président américain envers l’ancien British Petroleum (tentant difficilement de sauvegarder son nouveau positionnement de Beyond Petroleum).
14
Le cas Toyota, quoique différent, est également symptomatique de la forte corrélation entre la marque de grandes entreprises et l’image des États. Quelques jours après avoir présenté ses excuses devant le Parlement américain, le P.-D.G. Akio Toyoda a fait de même envers la Chine. Loin d’être soutenu par le gouvernement japonais, la société devenue symbole de la qualité made in Japan s’est fait vertement rabrouer par le ministre des Affaires étrangères Katsuya Okada ainsi que le ministre des Transports Seiji Maehara. Pour eux, à travers Toyota, c’est l’image du Japon qui était ternie.
15
Les déboires des géants automobile et pétrolier illustrent l’interdépendance des diplomaties économiques des pays et des entreprises et la nécessité pour les acteurs privés et publics d’intégrer cette imbrication dans leur stratégie.
0/5000
5/الدبلوماسية الاقتصادية للشركاتبيتي بارفرانكويس نائب رئيس التحالفات الاستراتيجية مجموعة من CAC 40 والتجارة الدولية المستشار.ودعا ل ه السلكية مجلة أمريكية في تشرين الأول/أكتوبر 2010 تدريس سبعة مواضيع جديدة تعتبر حيوية لفهم القرن الحادي والعشرين. مكانة بارزة وشملت الدبلوماسية غير التابعة للدولة، ولا سيما من الشركات.2العالم الجديد، والعولمة، ومترابطة، ثلاثية الأبعاد. الدول، وتركز الصلاحيات حتى الحرب العالمية الثانية، شهدت أعدادهم مضروبة في أربعة منذ. قوتها النسبية، تضعف، انخفضت كثيرا. زاد الدين العام المستوطنة منذ عظيم جيل الناشئ أو المتقاعدين البلد، هذا الاتجاه. في الوقت نفسه، هو ترجمة ظهور جماعات متعددة الجنسيات-في تسارع منذ السبعينات-بمظهر أكثر قوة من العديد من الجهات الفاعلة في البلدان. أخيرا، سمح الإنترنت الانفجار خلال العقد الماضي وضع القبائل العالمية المؤثرة الجمع بين الأفكار والآراء والأيديولوجيات في بعض الأحيان.3أثناء الحرب الباردة، والعديد من العلاقات بين الدول تتمحور حول العلاقة بين القوتين العظميين وكتل الخاصة بهم. جيلين في وقت لاحق أنها بالقرب من العناصر الفاعلة من 1000 (300 أكبر الدول والمناطق، Fortune 500 و 200 المنظمات مجموعات أو حركات للرأي السائد) التي تشكل الاتجاهات. كل ما تتطور في حركة البراونية تشكلها ملايين علاقات بين الأبعاد الثلاثة.4الجانبين أصبحت الأساسية في هذا العالم غير مستقر و "السائلة". كل فاعل، ضرب كالمخدرات التفاعلات، يسعى إلى تحقيق أقصى قدر من المكاسب الناجمة عن علاقات إيجابية (الشراكات)، وتقليل الصراعات.5يتوافق مع هذه الأولوية مزدوجة بالضبط الدعامتين الدبلوماسية. في بيئة سريعة تغير، يتعين على الشركات جاذبية متزايدة.لماذا الدبلوماسية الاقتصادية الأعمال التجارية؟ 6الشركات يجب أن تتكيف مع النموذج الجديد والهياكل الكلاسيكية للعلاقة مع العالم الخارجي، وأن كان ضروريا، لم تعد كافية.7ناقلات التقليدية للدعاية والاتصالات غالباً ما تكون سلبية جداً في هذا عالم متغير. أنهم، في شكلها الأصلي، أكثر ملاءمة لوجود حاجة إلى رد فعل فوري أثناء التفاعل مع الدول أو مع الملايين من 'prosumer' التي تستند إليها بسرعة.8من ناحية أخرى، كثيرا ما ينظر 'العلاقات الخارجية' و 'الضغط' المهام التي قد تؤثر على المعايير والقواعد والقوانين في بعض الأحيان بالجمهور كداع في محاولة للتأثير على سيادة الدولة-حتى عند الدولة التي تطلب رأي الصناعيين.9محاولات الأعمال الدبلوماسية الاقتصادية لتلبية الاحتياجات الجديدة من خلال الجمع بين عدة عناصر منفصلة الآن:• تناسبها في الأجل الطويل مع الاستجابة في الوقت الحقيقي.• أنها تتصل أساسا بعلاقات غير متجانسة (الأعمال التجارية-الدول، المنظمات شركات، تحركات الشركات الرأي...)؛• له دور وقائي في عالم حيث يكون تافها الصراع.وبالإضافة إلى ذلك، أنها تشاطر مع الدبلوماسية التقليدية ثلاث خصائص أساسية: أنها تركز أساسا على التفاعل عبر الحدود الوطنية. تقرر على أعلى مستوى للمنظمات: الدول أو المجتمعات أو جمعيات. وأخيراً، أنه يعطي الأهمية الاستراتيجية للتصور الدولي.10الدبلوماسية الاقتصادية يخدم الأهداف الرئيسية للشركات، أساسا فيها التقييم الشامل للشركة.11إدراك القيمة التجارية تطورت على مدى عدة عقود. أولاً قياس المحيط والمبيعات لذلك، أخذت بسرعة إلى حساب صافي الأرباح تحديث، ثم الكتابة بالأحرف الكبيرة. يتجاوز وزن المخزون، يبدأ القيمة الاندماج بالإشعاع من العلامة التجارية وسمعة الشركات. والرهانات كبيرة في عالم لوابل من المعلومات--من المفارقات--يسمح العلامة التجارية لعلامة 'من'. انتربراند شركة أصدرت في أيلول/سبتمبر 2010 مرتبته 100 العلامات التجارية العالمية الرائدة. سيتم منح شركة كوكا كولا في المقام الأول بقيمة تقدر بمبلغ 70.4 بیلیون. تويوتا، تأثرت بصورة العلامة التجارية كارثية في فبراير 2010 لاستدعاء ثمانية من النماذج (لمشاكل دواسة المسرع) فقدت 16% لمبلغ 26.2 بیلیون. المعهد سمعة متبوعاً بصورة متزايدة رابطات المستهلكين أيضا دبوس تويوتا ويجعل قضية في موقعها على الإنترنت. وأخيراً، يرى BP وقف خارج التصنيف بعد الكارثة الإيكولوجية الأمريكية ديبواتير بينما منافستها شل يصعد إلى ما يقرب من عشرة أماكن.12تزايد تتشابك المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية الاقتصادية تؤثر على الدبلوماسية السياسية. ديناميات العمل مختلفة جداً.13وفي حالة شركة بريتيش بتروليوم، تسببت الأزمة واضح التوتر السياسي بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى. تذكرت الاحتكاك بين باراك أوباما وحكومة براون Gordon خلال الهجمات المتكررة من الرئيس الأميركي إلى "شركة البترول البريطانية" السابقة (تسعى جاهدة لحفظ موقعها الجديد كخارج النفط).14حالة تويوتا، على الرغم من اختلاف، أيضا عرضاً من أعراض الترابط القوى بين العلامة التجارية الشركات والصورة للدول. أيام قليلة بعد وقد اعتذرت "البرلمان الأمريكي"، الرئيس واكيو تويودا الرئيس التنفيذي. فعل نفس الشيء تجاه الصين. أبعد ما تكون عن التي تدعمها "حكومة اليابان"، لقيت تم رفض المجتمع أصبح رمزاً للجودة في اليابان سيجي مايهارا وزير النقل ووزير الخارجية كاتسويا أوكادا. بالنسبة لهم، من خلال تويوتا، أنها صورة أن اليابان قد شوهت.15كيدي للسيارات وشركات النفط العملاقة توضيح الترابط بين الدبلوماسية الاقتصادية للبلدان والشركات، والحاجة لأصحاب المصلحة الخاصة والعامة لإدماج هذا التداخل في استراتيجيتها.
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..


5 شركات الدبلوماسية / الاقتصادية
parFrançois بيتي
نائب رئيس التحالفات الاستراتيجية لCAC 40 شركة ومستشار التجارة الخارجية.
T انه مجلة أمريكية السلكية في أكتوبر 2010 دعا إلى تدريس سبع تخصصات جديدة تعتبر أساسية لفهم الحادي والعشرين القرن. مكانة بارزة الدبلوماسية غير الحكومية، ولا سيما الشركات.
2
العالم الجديد، العولمة ومترابطة، هو ثلاثي الأبعاد. الدول، مع التركيز القوى حتى الحرب العالمية الثانية، وشهدت أعدادهم تضاعفت أربع مرات منذ ذلك الحين. قوتهم النسبية، مخففة، انخفضت تبعا لذلك. الدين العام المستشري في جيل واحد، باستثناء الدول الناشئة الكبيرة أو annuitants، وازدادت حدة هذا الاتجاه. في الوقت نفسه، وظهور جماعات متعددة الجنسيات - قد أدى إلى ظهور جهات فاعلة أكثر من العديد من البلدان - تسريع منذ 1970s. وأخيرا، فقد سمح للانفجار الإنترنت في العقد الأخير القبائل ذات النفوذ توحيد الأفكار التنمية العالمية والآراء والأيديولوجيات في بعض الأحيان.
3
خلال الحرب الباردة، وكثير العلاقات بين الولايات structuraient حول العلاقة بين الاثنين القوى العظمى وأقسامهم. بعد جيلين هناك ما يقرب من 1000 الفاعلين (أكبر من 300 دول ومناطق، ومجموعات من فورتشن 500 و 200 منظمة غير حكومية وحركات الرأي السائد) التي تشكل الاتجاهات الرئيسية. كل عمل في الحركة البراونية غرار من قبل الملايين من العلاقات بين الأبعاد الثلاثة.
4
جانبان تصبح أساسية في هذا العالم "السائل" غير مستقر و. كل لاعب، في الواقع ضرب التفاعلات، التي تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من المكاسب الناجمة عن علاقات بناءة (الشراكات) وتقليل الصراعات.
5
هذه الأولوية المزدوجة يتوافق بدقة لاثنين من ركائز الدبلوماسية. في بيئة متغيرة، فإن الشركات قد تزايد اللجوء.
لماذا الأعمال الدبلوماسية الاقتصادي؟
6
يجب أن الشركات التكيف مع النموذج الجديد والهياكل التقليدية للعلاقة مع الخارج، في حين لزم الأمر، ليست كافية .
7
وناقلات التقليدية الإعلان والاتصالات وغالبا ما تكون سلبية جدا في عالم متغير. وهم، في شكلها الأصلي، أكثر ملاءمة لحاجة لاتخاذ اللازم فورا عند التعامل مع الدول أو مع الملايين من "consumactors" التي توحد بسرعة.
8
وبالإضافة إلى ذلك، وظائف "العلاقات الخارجية" و "الضغط" التي يمكن أن تؤثر على المعايير والقواعد وأحيانا غالبا ما ينظر إليها القوانين من قبل الرأي العام على أنها محاولة لا مبرر له للتأثير على سيادة الدولة - حتى حيث تسعى الدولة وجهات النظر الصناعية
9
الدبلوماسية الاقتصادية خيمة للشركات الاستجابة للاحتياجات الجديدة من خلال الجمع بين عدة عناصر مفككة حتى الآن:
• أنها على المدى الطويل في حين الاستجابة في الوقت الحقيقي؛
• ارتباطه أساسا لعلاقات غير المتجانسة (ولايات الأعمال والمنظمات غير الحكومية والشركات وsociétés- الحركات الرأي ...)
• له دور وقائي في عالم حيث الصراعات شائعة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يشترك مع الدبلوماسية ثلاث خصائص أساسية التقليدية: أنه يركز في المقام الأول على التفاعلات العابرة للحدود الوطنية. تقرر على أعلى المستويات من المنظمات: الدول والشركات أو الجمعيات. وأخيرا، تولي أهمية استراتيجية للتصور الدولي.
10
الدبلوماسية الاقتصادية هي الأهداف التجارية الرئيسية، وفي مقدمتها التقييم العام للشركة.
11
وتصور قيمة الشركات قد تغيرت بشكل كبير منذ عقود. قياس الأولى من حيث النطاق وبالتالي المبيعات، وقالت انها تعتبر بسرعة صافي الربح والقيمة المخصومة. ما وراء الوزن الأوراق المالية، وتبدأ قيمة لدمج الإشعاع لهذه العلامة التجارية وسمعة الشركة. الرهانات عالية في العالم لوابل من المعلومات التي - للمفارقة - العلامة التجارية تساعد على "دي" النتيجة. شركة انتربراند نشرت في سبتمبر 2010 ترتيبه في قائمة أفضل 100 علامة تجارية عالمية. كوكا كولا كان يفوز بالمركز الأول مع التقييم تقدر 70400000000. علامة تويوتا، التي تأثرت صورة كارثية من الإستدعاء في فبراير 2010 ثمانية من نماذجها (لمشاكل دواسة) تفقد 16٪ إلى 26200000000 $. معهد التقييم يتبع بشكل متزايد من قبل جمعيات المستهلكين أيضا دبوس تويوتا في واقع الأمر دراسة حالة على موقعها على الانترنت. وأخيرا، يرى BP نفسه طردوا من التصنيف العالمي بعد الولايات المتحدة البيئي في المياه العميقة الكارثة بينما ارتفع منافسيها شل ما يقرب من عشرة الأماكن.
12
يعكس التداخل المتزايد من المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية الاقتصادية للتأثير على الدبلوماسية السياسية. ديناميكية في العمل هي متنوعة جدا.
13
وفي حالة BP، تسببت الأزمة توتر سياسي واضح بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى. علينا أن نتذكر الاحتكاك بين باراك أوباما وحكومة غوردون براون خلال الهجمات المتكررة من الرئيس الأمريكي لشركة البترول البريطانية السابق (في محاولة صعبة لإنقاذ منصبه الجديد ما بعد البترول).
14
إذا تويوتا، وإن كانت مختلفة، هو أيضا أعراض للارتباط قوي بين صورة الشركة والعلامة التجارية للدول. وبعد بضعة أيام اعتذر للبرلمان أمريكا، لم أكيو تويودا الرئيس التنفيذي للنفس إلى الصين. بعيدا عن كونه مدعوما من الحكومة اليابانية، أصبحت الشركة رمزا للجودة صنع في اليابان قد رفضت بشدة وزير الخارجية كاتسويا اوكادا ووزير النقل سيجي مايهارا. بالنسبة لهم، من خلال تويوتا وشوهت صورة اليابان.
15
ويلات السيارات والنفط العملاقة توضح الترابط بين الدبلوماسية الاقتصادية للبلدان والشركات والحاجة إلى الجهات الخاصة والعامة تعشش دمج ذلك في استراتيجيتها.
parFrançois بيتي
نائب رئيس التحالفات الاستراتيجية لCAC 40 شركة ومستشار التجارة الخارجية.
T انه مجلة أمريكية السلكية في أكتوبر 2010 دعا إلى تدريس سبع تخصصات جديدة تعتبر أساسية لفهم الحادي والعشرين القرن. مكانة بارزة الدبلوماسية غير الحكومية، ولا سيما الشركات.
2
العالم الجديد، العولمة ومترابطة، هو ثلاثي الأبعاد. الدول، مع التركيز القوى حتى الحرب العالمية الثانية، وشهدت أعدادهم تضاعفت أربع مرات منذ ذلك الحين. قوتهم النسبية، مخففة، انخفضت تبعا لذلك. الدين العام المستشري في جيل واحد، باستثناء الدول الناشئة الكبيرة أو annuitants، وازدادت حدة هذا الاتجاه. في الوقت نفسه، وظهور جماعات متعددة الجنسيات - قد أدى إلى ظهور جهات فاعلة أكثر من العديد من البلدان - تسريع منذ 1970s. وأخيرا، فقد سمح للانفجار الإنترنت في العقد الأخير القبائل ذات النفوذ توحيد الأفكار التنمية العالمية والآراء والأيديولوجيات في بعض الأحيان.
3
خلال الحرب الباردة، وكثير العلاقات بين الولايات structuraient حول العلاقة بين الاثنين القوى العظمى وأقسامهم. بعد جيلين هناك ما يقرب من 1000 الفاعلين (أكبر من 300 دول ومناطق، ومجموعات من فورتشن 500 و 200 منظمة غير حكومية وحركات الرأي السائد) التي تشكل الاتجاهات الرئيسية. كل عمل في الحركة البراونية غرار من قبل الملايين من العلاقات بين الأبعاد الثلاثة.
4
جانبان تصبح أساسية في هذا العالم "السائل" غير مستقر و. كل لاعب، في الواقع ضرب التفاعلات، التي تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من المكاسب الناجمة عن علاقات بناءة (الشراكات) وتقليل الصراعات.
5
هذه الأولوية المزدوجة يتوافق بدقة لاثنين من ركائز الدبلوماسية. في بيئة متغيرة، فإن الشركات قد تزايد اللجوء.
لماذا الأعمال الدبلوماسية الاقتصادي؟
6
يجب أن الشركات التكيف مع النموذج الجديد والهياكل التقليدية للعلاقة مع الخارج، في حين لزم الأمر، ليست كافية .
7
وناقلات التقليدية الإعلان والاتصالات وغالبا ما تكون سلبية جدا في عالم متغير. وهم، في شكلها الأصلي، أكثر ملاءمة لحاجة لاتخاذ اللازم فورا عند التعامل مع الدول أو مع الملايين من "consumactors" التي توحد بسرعة.
8
وبالإضافة إلى ذلك، وظائف "العلاقات الخارجية" و "الضغط" التي يمكن أن تؤثر على المعايير والقواعد وأحيانا غالبا ما ينظر إليها القوانين من قبل الرأي العام على أنها محاولة لا مبرر له للتأثير على سيادة الدولة - حتى حيث تسعى الدولة وجهات النظر الصناعية
9
الدبلوماسية الاقتصادية خيمة للشركات الاستجابة للاحتياجات الجديدة من خلال الجمع بين عدة عناصر مفككة حتى الآن:
• أنها على المدى الطويل في حين الاستجابة في الوقت الحقيقي؛
• ارتباطه أساسا لعلاقات غير المتجانسة (ولايات الأعمال والمنظمات غير الحكومية والشركات وsociétés- الحركات الرأي ...)
• له دور وقائي في عالم حيث الصراعات شائعة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يشترك مع الدبلوماسية ثلاث خصائص أساسية التقليدية: أنه يركز في المقام الأول على التفاعلات العابرة للحدود الوطنية. تقرر على أعلى المستويات من المنظمات: الدول والشركات أو الجمعيات. وأخيرا، تولي أهمية استراتيجية للتصور الدولي.
10
الدبلوماسية الاقتصادية هي الأهداف التجارية الرئيسية، وفي مقدمتها التقييم العام للشركة.
11
وتصور قيمة الشركات قد تغيرت بشكل كبير منذ عقود. قياس الأولى من حيث النطاق وبالتالي المبيعات، وقالت انها تعتبر بسرعة صافي الربح والقيمة المخصومة. ما وراء الوزن الأوراق المالية، وتبدأ قيمة لدمج الإشعاع لهذه العلامة التجارية وسمعة الشركة. الرهانات عالية في العالم لوابل من المعلومات التي - للمفارقة - العلامة التجارية تساعد على "دي" النتيجة. شركة انتربراند نشرت في سبتمبر 2010 ترتيبه في قائمة أفضل 100 علامة تجارية عالمية. كوكا كولا كان يفوز بالمركز الأول مع التقييم تقدر 70400000000. علامة تويوتا، التي تأثرت صورة كارثية من الإستدعاء في فبراير 2010 ثمانية من نماذجها (لمشاكل دواسة) تفقد 16٪ إلى 26200000000 $. معهد التقييم يتبع بشكل متزايد من قبل جمعيات المستهلكين أيضا دبوس تويوتا في واقع الأمر دراسة حالة على موقعها على الانترنت. وأخيرا، يرى BP نفسه طردوا من التصنيف العالمي بعد الولايات المتحدة البيئي في المياه العميقة الكارثة بينما ارتفع منافسيها شل ما يقرب من عشرة الأماكن.
12
يعكس التداخل المتزايد من المجالات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية الاقتصادية للتأثير على الدبلوماسية السياسية. ديناميكية في العمل هي متنوعة جدا.
13
وفي حالة BP، تسببت الأزمة توتر سياسي واضح بين الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى. علينا أن نتذكر الاحتكاك بين باراك أوباما وحكومة غوردون براون خلال الهجمات المتكررة من الرئيس الأمريكي لشركة البترول البريطانية السابق (في محاولة صعبة لإنقاذ منصبه الجديد ما بعد البترول).
14
إذا تويوتا، وإن كانت مختلفة، هو أيضا أعراض للارتباط قوي بين صورة الشركة والعلامة التجارية للدول. وبعد بضعة أيام اعتذر للبرلمان أمريكا، لم أكيو تويودا الرئيس التنفيذي للنفس إلى الصين. بعيدا عن كونه مدعوما من الحكومة اليابانية، أصبحت الشركة رمزا للجودة صنع في اليابان قد رفضت بشدة وزير الخارجية كاتسويا اوكادا ووزير النقل سيجي مايهارا. بالنسبة لهم، من خلال تويوتا وشوهت صورة اليابان.
15
ويلات السيارات والنفط العملاقة توضح الترابط بين الدبلوماسية الاقتصادية للبلدان والشركات والحاجة إلى الجهات الخاصة والعامة تعشش دمج ذلك في استراتيجيتها.
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..


5 / الدبلوماسية الاقتصادية parfran ç ois Pitti
نائب رئيس شركة التحالف الاستراتيجي من مجموعة من المستشارين كاك 40 و التجارة الخارجية ل ه.......
طلب الاتصال من المجلة الأمريكية في 7 أكتوبر 2010 الجديد ضرورة فهم موضوع التعليم في القرن الحادي والعشرين.في الدول الخارجية غير جيدة،وخاصة المشاريع.......
2 في العالم الجديد، العولمة ومترابطة، ثلاثي الأبعاد.الدولة مركزية السلطة، حتى أثناء الحرب العالمية الثانية ترى عددهم أربع مرات.أنها القوة النسبية، تمييع، ويقلل من الكثير.الدين العام من جيل شعبية كبيرة، من البلدان الناشئة أو الريعية،تفاقم هذا الاتجاه.وفي الوقت نفسه، مجموعة متعددة الجنسيات في السبعينات من القرن الماضي تسريع – يؤدي إلى العديد من الجهات من أقوى الدول.وأخيرا، الإنترنت انفجرت في العقد الماضي زيادة النفوذ العالمي تأثير القبيلة أكثر الأفكار، الآراء، وأحيانا 3
الأيديولوجية.في فترة الحرب الباردة، في العديد من البلدان في العلاقات بين القوتين العظميين 276 - هذا القانون بما في ذلك علاقة ذات كتلة.بعد جيلين، ما يقرب من 1 مليون مشارك (300 من أكبر البلدان والمناطق، مجموعة فورتشن 500 و 200 منظمة أو حركة توجيه الرأي العام في اتجاه خلق).جميع التطورات في الحركة البراونية من الملايين من بين ثلاثة أبعاد.......
4 اثنين من الجوانب الأساسية مستقرة، أصبح العالم "السائل".كل فاعل، حقائق التفاعل، للحصول على أقصى قدر من الأرباح الناجمة عن علاقات بناءة (الشراكة) والحد من الصراعات. 5
هذا ضعف الأولوية بالضبط مقابل اثنين من الدبلوماسية.في بيئة سريعة التغير، المزيد والمزيد من الشركات.......
لماذا الدبلوماسية الاقتصادية الشركة؟
6 يجب على الشركات التكيف مع نموذج جديد و البنية التقليدية مع العلاقات الخارجية، وإن كانت ضرورية، ليست كافية....... 7
الإعلان التقليدية في كثير من الأحيان الناقل ونشر الحركة السلبية في العالم.في شكله الأصلي، وأكثر مناسبة تتطلب استجابة فورية عند التفاعل مع الدول أو مليون "consommacteurs" f é d è هي بسرعة.......
آخر 8وظائف "العلاقات الخارجية" و "اللوبي"، وهذا قد يؤثر على مستوى القواعد والقوانين، في بعض الأحيان يتم إغراء الإفراط في الرأي العام تؤثر على السيادة الوطنية الوطنية – حتى التحيز الرأي
9 الصناعية.المؤسسة الدبلوماسية الاقتصادية، في محاولة لتلبية مجموعة جديدة من عناصر متعددة هنا فصل:
• انها على المدى الطويل مع الاستجابة في الوقت الحقيقي؛
• أنها تتعلق أساسا العلاقة غير متجانسة (الشركات الأعضاء، والمنظمات التجارية، الشركات آراء حركة …)؛
• وقد منع الصراعات تنتشر في العالم.......
كما مع الدبلوماسية التقليدية: ثلاث خصائص أساسية لها الأولوية عبر التفاعل.قررت المنظمة في مستوى أعلى من الدولة أو شركة أو جمعية.وأخيرا، لها أهمية استراتيجية الرؤية الدولية.
10 الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها المؤسسة الأهداف الرئيسية، أولا، تعزيز المجتمع.......
11 إدراك قيمة المشاريع في غضون عقود من تطور كبير.أولا، من خلال قياس محيط، لذلك المبيعات، وقالت أنها بسرعة النظر في صافي الربح الخصم، ثم رأس المال.وبصرف النظر عن وزن الأسهمبدأ العلامة التجارية قيمة الإشعاع و سمعة الشركة....... كبيرة من هذه التناقضات في عالم المعلومات قصف – العلامة التجارية يمكن أن "الكشتبان" مارك.......أصدرت شركة انتربراند في أيلول / سبتمبر 2010 صاحب الترتيب العالمي 100 العلامة التجارية.كوكا كولا هي أول حصة تقدر بـ 70.4 بليون دولار في التقييم.صورة العلامة التجارية من آثار مدمرة، تويوتا أذكر في 8 فبراير 2010 نموذج (دواسة) فقدت 16% 26.2 مليون دولار.المعهد سمعة أكثر وأكثر من قبل جمعية المستهلك أيضا دبوس تويوتا و حالة المدرسة في موقعها.وأخيرا، يمكن السيارة من نوع بي بي بعد كارثة بيئية مع منافسيها في المياه العميقة في الولايات المتحدة ارتفع ما يقرب من 10 علامة شل.......
12 متداخلة المتزايد في المجالات السياسية والاقتصادية،الدبلوماسية الاقتصادية التي تؤثر في السياسة الخارجية.قوة العمل هي مختلفة جدا.......
في 13 حالة بي بي، قد تسبب في أزمة واضحة التوترات السياسية بين الولايات المتحدة و بريطانيا.نحن نتذكر الاحتكاك بين أوباما و براون في نوبات متكررة من الرئيس الأمريكي على شركة النفط البريطانية (قبل محاولة الحفاظ على التوجه الجديد من الصعب تجاوز البترول).......
على الرغم من تويوتا 14 حالة مختلفةهناك أيضا أعراض قوية بين الشركات الكبيرة و صورة العلامة التجارية في البلد.وبعد بضعة أيام، الكونغرس الأمريكي اعتذر الرئيس أكيو تويودا في الصين أيضا..............لا تدعم الحكومة اليابانيةأصبحت الشركة رمز الجودة في اليابان هو وقح جداً وزير الخارجية كاتسويا اوكادا ووزير النقل مايهارا.......بالنسبة لهم، من خلال شركة تويوتا اليابان هو تشويه صورة....... 15
سيارات و شركات النفط العملاقة أن الدبلوماسية الاقتصادية النكسات الترابط بين البلدان والشركات، إلى أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص أن هذه الاستراتيجية
.
نائب رئيس شركة التحالف الاستراتيجي من مجموعة من المستشارين كاك 40 و التجارة الخارجية ل ه.......
طلب الاتصال من المجلة الأمريكية في 7 أكتوبر 2010 الجديد ضرورة فهم موضوع التعليم في القرن الحادي والعشرين.في الدول الخارجية غير جيدة،وخاصة المشاريع.......
2 في العالم الجديد، العولمة ومترابطة، ثلاثي الأبعاد.الدولة مركزية السلطة، حتى أثناء الحرب العالمية الثانية ترى عددهم أربع مرات.أنها القوة النسبية، تمييع، ويقلل من الكثير.الدين العام من جيل شعبية كبيرة، من البلدان الناشئة أو الريعية،تفاقم هذا الاتجاه.وفي الوقت نفسه، مجموعة متعددة الجنسيات في السبعينات من القرن الماضي تسريع – يؤدي إلى العديد من الجهات من أقوى الدول.وأخيرا، الإنترنت انفجرت في العقد الماضي زيادة النفوذ العالمي تأثير القبيلة أكثر الأفكار، الآراء، وأحيانا 3
الأيديولوجية.في فترة الحرب الباردة، في العديد من البلدان في العلاقات بين القوتين العظميين 276 - هذا القانون بما في ذلك علاقة ذات كتلة.بعد جيلين، ما يقرب من 1 مليون مشارك (300 من أكبر البلدان والمناطق، مجموعة فورتشن 500 و 200 منظمة أو حركة توجيه الرأي العام في اتجاه خلق).جميع التطورات في الحركة البراونية من الملايين من بين ثلاثة أبعاد.......
4 اثنين من الجوانب الأساسية مستقرة، أصبح العالم "السائل".كل فاعل، حقائق التفاعل، للحصول على أقصى قدر من الأرباح الناجمة عن علاقات بناءة (الشراكة) والحد من الصراعات. 5
هذا ضعف الأولوية بالضبط مقابل اثنين من الدبلوماسية.في بيئة سريعة التغير، المزيد والمزيد من الشركات.......
لماذا الدبلوماسية الاقتصادية الشركة؟
6 يجب على الشركات التكيف مع نموذج جديد و البنية التقليدية مع العلاقات الخارجية، وإن كانت ضرورية، ليست كافية....... 7
الإعلان التقليدية في كثير من الأحيان الناقل ونشر الحركة السلبية في العالم.في شكله الأصلي، وأكثر مناسبة تتطلب استجابة فورية عند التفاعل مع الدول أو مليون "consommacteurs" f é d è هي بسرعة.......
آخر 8وظائف "العلاقات الخارجية" و "اللوبي"، وهذا قد يؤثر على مستوى القواعد والقوانين، في بعض الأحيان يتم إغراء الإفراط في الرأي العام تؤثر على السيادة الوطنية الوطنية – حتى التحيز الرأي
9 الصناعية.المؤسسة الدبلوماسية الاقتصادية، في محاولة لتلبية مجموعة جديدة من عناصر متعددة هنا فصل:
• انها على المدى الطويل مع الاستجابة في الوقت الحقيقي؛
• أنها تتعلق أساسا العلاقة غير متجانسة (الشركات الأعضاء، والمنظمات التجارية، الشركات آراء حركة …)؛
• وقد منع الصراعات تنتشر في العالم.......
كما مع الدبلوماسية التقليدية: ثلاث خصائص أساسية لها الأولوية عبر التفاعل.قررت المنظمة في مستوى أعلى من الدولة أو شركة أو جمعية.وأخيرا، لها أهمية استراتيجية الرؤية الدولية.
10 الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها المؤسسة الأهداف الرئيسية، أولا، تعزيز المجتمع.......
11 إدراك قيمة المشاريع في غضون عقود من تطور كبير.أولا، من خلال قياس محيط، لذلك المبيعات، وقالت أنها بسرعة النظر في صافي الربح الخصم، ثم رأس المال.وبصرف النظر عن وزن الأسهمبدأ العلامة التجارية قيمة الإشعاع و سمعة الشركة....... كبيرة من هذه التناقضات في عالم المعلومات قصف – العلامة التجارية يمكن أن "الكشتبان" مارك.......أصدرت شركة انتربراند في أيلول / سبتمبر 2010 صاحب الترتيب العالمي 100 العلامة التجارية.كوكا كولا هي أول حصة تقدر بـ 70.4 بليون دولار في التقييم.صورة العلامة التجارية من آثار مدمرة، تويوتا أذكر في 8 فبراير 2010 نموذج (دواسة) فقدت 16% 26.2 مليون دولار.المعهد سمعة أكثر وأكثر من قبل جمعية المستهلك أيضا دبوس تويوتا و حالة المدرسة في موقعها.وأخيرا، يمكن السيارة من نوع بي بي بعد كارثة بيئية مع منافسيها في المياه العميقة في الولايات المتحدة ارتفع ما يقرب من 10 علامة شل.......
12 متداخلة المتزايد في المجالات السياسية والاقتصادية،الدبلوماسية الاقتصادية التي تؤثر في السياسة الخارجية.قوة العمل هي مختلفة جدا.......
في 13 حالة بي بي، قد تسبب في أزمة واضحة التوترات السياسية بين الولايات المتحدة و بريطانيا.نحن نتذكر الاحتكاك بين أوباما و براون في نوبات متكررة من الرئيس الأمريكي على شركة النفط البريطانية (قبل محاولة الحفاظ على التوجه الجديد من الصعب تجاوز البترول).......
على الرغم من تويوتا 14 حالة مختلفةهناك أيضا أعراض قوية بين الشركات الكبيرة و صورة العلامة التجارية في البلد.وبعد بضعة أيام، الكونغرس الأمريكي اعتذر الرئيس أكيو تويودا في الصين أيضا..............لا تدعم الحكومة اليابانيةأصبحت الشركة رمز الجودة في اليابان هو وقح جداً وزير الخارجية كاتسويا اوكادا ووزير النقل مايهارا.......بالنسبة لهم، من خلال شركة تويوتا اليابان هو تشويه صورة....... 15
سيارات و شركات النفط العملاقة أن الدبلوماسية الاقتصادية النكسات الترابط بين البلدان والشركات، إلى أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص أن هذه الاستراتيجية
.
يجري ترجمتها، يرجى الانتظار ..


لغات أخرى
دعم الترجمة أداة: الآيسلندية, الأذرية, الأردية, الأفريقانية, الألبانية, الألمانية, الأمهرية, الأوديا (الأوريا), الأوزبكية, الأوكرانية, الأويغورية, الأيرلندية, الإسبانية, الإستونية, الإنجليزية, الإندونيسية, الإيطالية, الإيغبو, الارمنية, الاسبرانتو, الاسكتلندية الغالية, الباسكية, الباشتوية, البرتغالية, البلغارية, البنجابية, البنغالية, البورمية, البوسنية, البولندية, البيلاروسية, التاميلية, التايلاندية, التتارية, التركمانية, التركية, التشيكية, التعرّف التلقائي على اللغة, التيلوجو, الجاليكية, الجاوية, الجورجية, الخؤوصا, الخميرية, الدانماركية, الروسية, الرومانية, الزولوية, الساموانية, الساندينيزية, السلوفاكية, السلوفينية, السندية, السنهالية, السواحيلية, السويدية, السيبيوانية, السيسوتو, الشونا, الصربية, الصومالية, الصينية, الطاجيكي, العبرية, العربية, الغوجراتية, الفارسية, الفرنسية, الفريزية, الفلبينية, الفنلندية, الفيتنامية, القطلونية, القيرغيزية, الكازاكي, الكانادا, الكردية, الكرواتية, الكشف التلقائي, الكورسيكي, الكورية, الكينيارواندية, اللاتفية, اللاتينية, اللاوو, اللغة الكريولية الهايتية, اللوكسمبورغية, الليتوانية, المالايالامية, المالطيّة, الماورية, المدغشقرية, المقدونية, الملايو, المنغولية, المهراتية, النرويجية, النيبالية, الهمونجية, الهندية, الهنغارية, الهوسا, الهولندية, الويلزية, اليورباية, اليونانية, الييدية, تشيتشوا, كلينجون, لغة هاواي, ياباني, لغة الترجمة.
- وانتي
- جميلتي
- نلاحظ تزايد في معدل السكانالى حوالي
- لماذا غلق الكاميرا
- اريد ان امص لسانك
- لماذا غلق الكاميرا
- الجنس مقابل ٥٠٠ ريال
- زیاد
- beeg
- Mashindisr
- _ maryam.
- حيوان ينيك سيده
- Mashindisr
- . Is corporate disclosure of information
- Mashindisr
- حيوان ينيك سيده
- มีไร
- البعير
- Die within 30 seconds
- ESTAMOS
- Fuels
- لكل بداية نهاية
- من شمال المغرب
- جميلتي